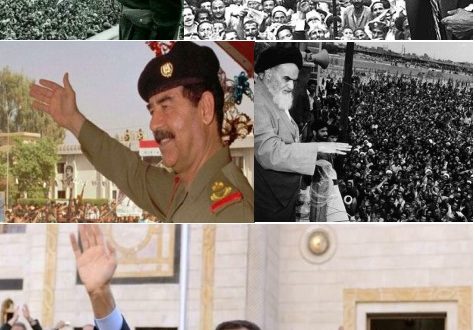كتب : أمجد حميد ـ العراق
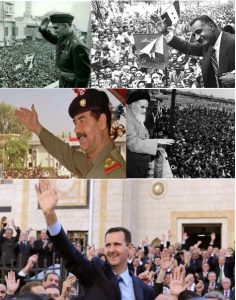 نظّم الانسان نفسه, مذ بدأت الخليقة, كما نظمها أقرانه من باقي الكائنات, بدون ان يحتاج الى دلالة مادية او منظورة ليثبته ويبعده عن التمرد على المعتاد وفطرته, راضياً خاضعاً للطبيعة وشروطها. فعدو كل كائن, من اول لحظة يخرج منها من حاضنته, هو الخروج على المعتاد, حتى لو كلف ذلك خسارة الحياة بذاتها. ولا احد يستطيع ان يحدد اللحظة الكونية التي قرر الانسان ان يخرج بها عن المعتاد وينشأ اختراعاً خارج البيولوجيا الكونية اسمه الحضارة, أول رمز للتمرد على الطبيعة الوجودية, بل الحيرة الكبرى هي معرفة اللحظة التي ادرك بها الانسان ان خضوعه للطبيعة, كسائر الخليقة, بالإمكان كسره واعتلاءه, فخلق حاجة الخضوع لكيان جديد يخصه ويغيره كما يشاء عكس الطبيعة التي صورته, بدل البقاء خاضعاً للطبيعة وقوانينها حتى وان كان الشيء الجديد الذي يخضع له وهماً محضاً.
نظّم الانسان نفسه, مذ بدأت الخليقة, كما نظمها أقرانه من باقي الكائنات, بدون ان يحتاج الى دلالة مادية او منظورة ليثبته ويبعده عن التمرد على المعتاد وفطرته, راضياً خاضعاً للطبيعة وشروطها. فعدو كل كائن, من اول لحظة يخرج منها من حاضنته, هو الخروج على المعتاد, حتى لو كلف ذلك خسارة الحياة بذاتها. ولا احد يستطيع ان يحدد اللحظة الكونية التي قرر الانسان ان يخرج بها عن المعتاد وينشأ اختراعاً خارج البيولوجيا الكونية اسمه الحضارة, أول رمز للتمرد على الطبيعة الوجودية, بل الحيرة الكبرى هي معرفة اللحظة التي ادرك بها الانسان ان خضوعه للطبيعة, كسائر الخليقة, بالإمكان كسره واعتلاءه, فخلق حاجة الخضوع لكيان جديد يخصه ويغيره كما يشاء عكس الطبيعة التي صورته, بدل البقاء خاضعاً للطبيعة وقوانينها حتى وان كان الشيء الجديد الذي يخضع له وهماً محضاً.
يسجل هذا الموقف بداية ادراك الانسان حاجته الجوهرية لكيان يخضع له كبديل لخضوع الطبيعة الذي يساويه بكل دابة في الارض وطائر يطير بجناحيه. وسميت هذه الفكرة اخيراً مجملاً بالقانون, والذي ولد لحظة نشأة الحضارة والمجتمع البشري الجديد ليكون العامل الاساسي في تكوينها, سواء كانت على شكل حاكم يصدرها او لوح محفوظ يرعاها ثلة من القوم, بانتخابهم كان او تفويضهم من قبل الحاكم. ولسنا بصدد تناولها بالشكل التأسيسي, كونه ليس من اختصاصنا ذلك وليس غاية بحثنا من الاساس, بل سيتم تناول العلاقة الترابطية والهيكلية التي يحملها الدستور والقوانين البشرية من جانب, والصيغة الدستورية, بمختلف قوانينها المحمولة, وعلاقتها بالمجتمع من جانب اخر.
ولن يختلف تعريفنا للدستور عن شكل وغاية بحثنا كثيراً, فلا التعريف الاكاديمي ولا التعاريف الفلسفية المختلفة ستكون قريبة من نهجنا النقدي المجتمعي, خصوصاً وان النقطة التي نريد ان نصل اليها هي الفكر العربي والمشاكل الدستورية التي يحملها. لكن لا ضير من اختصار فكرة القوانين وهيئتها العامة بالصورة التعريفية التي قدمها لنا مونتسكيو في كتابه “روح الشرائع” اذ قال:
“القوانين, في أوسع معناها, هي العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الاشياء, ولجميع الموجودات قوانينها من هذه الناحية. فللألوهية قوانينها وللعالم المادي قوانينه. وللأفهام التي هي أسمى من الأنسان قوانينها, وللحيوانات قوانينها, وللإنسان قوانينه.” (روح الشرائع, ص49)
نرى استنباط الصورة الموضوعية السابقة, مع اضافة الرؤية التاريخية, قد خلقت منظوراً جوهرياً وبسيطاً للقارئ عن ماهية القوانين ومفهومها, ولا ينتج هذا المنظور تعريفاً وماهية لمفهوم الدستور سوى انه الاداة البديلة للطبيعة لإخضاع المحكوم شرطاً, سواء كان تشكيلها بالفرد الحاكم او افراد حاكمين او وثيقة مكتوبة مطلوبة منها اخضاع الحاكم والمحكوم معاً. ولان جميع الحضارات القديمة قد عرفت ان تسليم الخضوع لفرد حي فانِ قد يوصله لجنون العظمة ويصبح الهاً على رعيته, نشأت فكرة القوانين الوضعية والمنفصلة عن كيان التابع لهذه القوانين والذي يديرها ايضاً حتى لو كان يرى نفسه الهاً. ورغم استمرار وجود حقب تاريخية تحمل شعوباً لا تمتلك هيئة قانونية سوى من يحكمها, الا ان تلك الحالات اثبتت فشلها تاريخياً كون الحاكم هو القانون بعينه, وحتى مع الاستثناءات التاريخية مثل حضارة الفراعنة المصرية نجد هذا النموذج غير فعال باي قاعدة منطقية بسيطة كانت او معقدة. لذا فهي مستبعدة في البحث هذا لانقراضها الاسمي, ونقول اسمي كون أساس هذا النموذج موجود الى اليوم لكن مع التستر سياسياً خلف حفنة من القوانين الوضعية كما سنثبت لاحقاً.
بهذه الطريقة نكتشف ان فكرة القوانين تستند في خلقها على الانسان لا على قوة تعتليه, او ينتمي اليها جذرياً, فان مواجهة القوانين الوضعية, بشكلها البشري كان او النصي, تسمى خرقاً ومواجهةً لا تحدياً, لان كل قانون بالتاريخ, بما يشمل النصوص الابراهيمية بمختلف جدليات وقعها, هي نصوص وهياكل وضعية, قناعة الانسان واعترافه بها وتفعيله لها هو ما يضفي شرعيتها بل حتى وجودها. فالحاكم الذي يحكم شعباً, سواء تحت مضلة دستورية او هو المضلة عينها, لن يكون حاكماً حين يقرر الجميع, بمن فيهم من تحت يده, انه حاكم. وان اي مجموعة قوانين بشرية, مكتوبة كانت او محفوظة متوارثة عرفية, هي قوانين لا حول لها ولا قوة على الانسان قط, فبإمكان الفرد خرقها وبإمكان الجمهور أسقاط شرعيتها وسلطانها. فالحقيقة النهائية التي نريد ان نعتمدها ونتبعها في هذا البحث هي ان الانسان هو مصدر الشرعية للقوانين وليست القوانين بذاتها مهما تشابهت واختلفت بين شعب واخر, فالإنسان هو من يعطي شرعية خضوعه لهذه القوانين, ولا سلطان للقوانين, ان كانت بشراً او نصاً, على فرد من الشعب قط سوى ما يسمح بها الفرد بنفسه.
يتكشّف لدينا الان ابعاد وخلفية الفكرة الناشئة المسماة بالقوانين او الدستور ككل, وترسم لنا في الان ذاته تبعات شروطها ومدى فهمها لدى طرف الحاكم والمحكوم. ما يعني بلا نقاش ان تعاطي الحاكم لأسس تكوين قوانين البقعة التي يحكمها ستختلف جذرياً عن المحكوم, وان كان احد اسس تكوينها هي موافقة المحكوم بالشكل الانتخابي. بل ان تبدّل الحاكم ومبادئه, سواء كان هذا التغير داخلياً او استعمارياً, قد ينذر بتغير هيئة او تطبيق هذا الشكل الدستوري المتفق عليه. وليس صدفة ان يرى نيكولو ميكافيلي في كتابه “الأمير” مدى حساسية تبدًل القوانين وصياغتها ومن يحافظ عليها على شعب من الشعوب:
“عندما تكون تلك الدول التي تم الاستيلاء عليها معتادة على الحياة الحرة في ظل قوانينها الخاصة, هناك ثلاث طرق للسيطرة عليها: فإما أن يلغيها الأمير أو أن يذهب بنفسه, ويعيش هناك او ان يسمح لها بالاستمرار في استخدام القوانين السابقة مع دفع الجزية. ونوجد داخل الدولة حكومة مكونة من عدد قليل ممن يحافظون على ولائها لك. ولأن هذه الحكومة التي شكلها الأمير تعرف انها لا يمكن ان تستمر بدون رضائه وحمايته, فهي ستفعل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الرضا وهذه الحماية. ومن جهة اخرى فان المدينة التي اعتادت الحياة بحرية يمكن السيطرة عليها من خلال مواطنيها أكثر من اي طريقة اخرى, وذلك اذا اردت ان تستمر هذه السيطرة.” (الأمير, ص36)
بهذه الصورة بنيت القوانين والدساتير الاوروبية باختصار عظيم, وبها انشأت هياكلها الاستعمارية التي توسعت آنذاك. بل ان هذه القاعدة الجوهرية هي ما تخلق التساؤل المطروح دائماً: ما هو الفرق بين شكل القوانين الغربي والعربي, وهو ما سنصل الى اجابته النهائية لاحقاً بان تصميم الدساتير الغربية تصميم مُستَعمِر, اما تصميم الدساتير العربية فهي تصميم مُستَعمَر. هذا ما يكفينا للقفز نحو تناول الدساتير العربية والشرق اوسطية, او التركيبة القانونية وكيميائيتها مع شعوبها, محاولين فهم مدى البعد الدائم والحاصل بالفترات التاريخية المتكررة الى اليوم وأسبابه. لان كلام ميكافيلي هو ما تم تطبيقه على دولنا الحديثة بعد انتهاء الدولة العثمانية تماماً, وهي ما ستؤكد لنا طبيعة العلاقة الطردية بين شكل الحاكم ومدى تطبيق القوانين المنصوصة او الوعود الموثقة ليصيغ من خلالها شكل الدولة وطريقة حكم الشعب مع حمل السطور الدستورية جنة موعودة له.
من الطبيعي ان يتم تفسير كلامنا على ان اغلب الدساتير العربية, ان لم يكن كلها, هي نتيجة ما بعد الاستعمار او الاستقلال الدولي, اي انها خاضعة بصورة لاإرادية لنتاجات هذا الاستعمار او الامة التي كان ينتمي لها, حتى وان ادعينا بمختلف الاشكال انها تمثل صورة شعبية مستقلة عن ارثها المستعمر. وقبل ان نوضح الأسس الدستورية الاساسية الموروثة من التأثر الاستعماري والممزوجة مع الذائقة الشعبية كذلك, دعونا نقدم لكم مثالاً بسيطاً بإمكاننا اعتماده كدعامة واشارة اساسية لكل ما سيلي في هذا البحث من شرح, وهو نص المادة 114 من دستور المملكة العراقية في سنة 1925 والذي يقول الاتي:
“جميع البيانات, والنظامات, والقوانين التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق, والحاكم الملكي العام, والمندوب السامي, التي اصدرتها حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت بين اليوم الخامس من تشرين الثاني 1914 وتاريخ تنفيذ هذا القانون الأساسي, تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها, وما لم يلغ منها الى هذا التاريخ , يبقى مرعياً الى ان تبدله او تلغيه السلطة التشريعية, أو الى ان يصدر من المحكمة العليا قرار يجعلها ملغاة بموجب أحكام المادة (86).” (دستور المملكة العراقية, مادة 114)
لا يظهر, سواء بالنظرة السطحية التي سنحاول الاعتماد عليها نسبياً او النظرة التقليدية الاكاديمية, اي ملامح للاستقلال او مفهوم الدولة بمعناها المعتاد في هذا النص, وهو ما سنلاحظه كثيراً سواء ظهر بظاهر النص او بباطنه, فالمثير للدهشة هو ان المادة 113 التي سبقت الاولى تسمح بنفاذ القوانين العثمانية مع مراعات التغيرات التي تكلمت عنها المادة 114. هذا ما يكشف لنا الحقيقة التي سنصل اليها لاحقاً, وهي ان الدساتير العربية ليست سوى نتاجات مجتمعية لحظية, استعمارية, او ما بعد استعمارية, او حتى صياغة منظومة ديكتاتورية, وليست نتاج مطالبات حقوقية لا تتغير مع تغير الزمن, بل ان توفرها النصي لا يكفي مالم تكن هناك جهود وتنظيم حقيقي لتحقيقها. ومن هذا المنطلق نستطيع ان نختزل الدعامات الاساسية ,التي منبعها الشعب والتشكيلات السياسية المعاصرة لكتابة اي دستور, الى ثلاث دعامات اساسية: التبعية السياسية, الانتمائية المجتمعية, والصلاحية التاريخية.
تتمثل التبعية السياسية كأساس ممثل للدولة بكل عناصرها الادارية, فكون الافراد الحاكمين هم غالباً جزء من المجتمع, في دولة مستقلة او مستعمرة, لا يمنع اختلاف مشاربهم والوانهم الفكرية عنه, فبالنهاية ان تكون حاكماً غير ان تكون محكوماً. ما يعني حملهم على الاغلب تيار فكري معين يبرر ويفسر قراراتهم وتصرفاتهم. بل ان هذا التيار الفكري الذي يملكونه قد لا يكونوا مؤمنين به وجدانياً بشكل كامل او انه لا يمثل سوى اقلية سياسية داخل البلد المعني. ومن هذه النقطة تنطلق بشائر الحكم الديكتاتوري سواء على شكل فرد, مثل صدام حسين وعائلة الاسد في حزب البعث والسيسي في مصر, او مؤسسة, مثل الحكومة الخمينية في ايران. فالشكل الاول الفرداني يتشكل حركياَ تحت مظلة الزعامة السياسية والحكم, فتغطي بمظلتها الدستور الناظم للمجتمع سواء باستغفاله عاطفياً بالاستفتاءات المزورة للتعديل او حتى الفرض الإجباري ان توجب الأمر, فيحصر, او يلغي, شرعية اي سلطة تعتليه او تحد سيطرته. وفي ذلك امثلة كثيرة نستهلها بالدستور السوري الصادر سنة 2012 كونه احد الدوافع الأساسية لهذا المقال, اذ سترون في المواد الدستورية التالية ما يصرخ بالتناقض عند اي شخص بسيط:
المادة 113:
“1. يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.“
المادة 132:
“السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.”
المادة 133:
“1. يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.“
ترينا تناقضات المواد الثلاثة المذكورة احد مفاتيح انهاء السلطة القانونية او الدستور في اي بلد معين, انه الاحتكار السياسي الذي سيحققه النص للحاكم. ومن المفارقة ان نرى الدستور مبرراً للحاكم وسيفاً له على المحكوم في ان واحد, لان حقيقة كل دستور انشائي التكوين واحتكاري السلطة هي ان منابعه الاساسية تتأتى من كونها خادمة ومصنوعة لأجل من يحكم لا من تحت الحكم. لذا نرى هذه المواد موجودة, مع تعديلات بسيطة وتافهة, منذ حكم حافظ الاسد بانقلابه على سلطة البعث سنة 1970, محولاً التيار الفكري الحزبي من فكرة ذات اطر واسع الى احتكار عائلي متوارث.
يتعقد المشهد الدستوري, سواء في تكوينه او في السعي لتغيير هذا التكوين, حين نفهم الانتمائية المجتمعية ومدى تأثيرها على صناعة الدستور من ذاتها اولاَ, ومع استغلالها بصياغتها وفق التبعية السياسية لتكون جزءً منها ثانياً. ولان منابع هذا العامل تنشأ من الاطر الفكرية المجتمعية, وهي ليست سوى نتاج اعتقاداتهم وتشكيلها حسب المنفعة الجماعية, فان التشكيل التنظيمي الذي سيطمح له افراد هذه المجموعة, ببساطة عقولهم وقدراتهم الفكرية المحدودة, لا يتعدى المحمولات التاريخية الموجودة في حيز تحديده وتأطيره للمنهجية الدستورية التي يسعى للموافقة عليها في استفتاءات حقيقية او استبدادية شكلية. وليس من الغريب ان نرى توحداً نظرياً عند الشعوب العربية في اخضاع دساتيرها للمسوغ التاريخي الذي يعيشون فيه وللتوجهات العقائدية التي تمثل الاغلبية. ونكاد لا نحتاج ان نثبت هذا الجزء من البحث كون الجميع مدرك, حد البديهة, ان المنظومة الدستورية الحاكمة معتمدة على حكم الاغلبية بحسب المنظور العربي العام, ولان هذه الامة, في مختلف بلدانها, ترى وفق هذا المقياس انها الطريقة الصحيحة والافضل لحكم دولهم, فان كل الدساتير العربية او الشرق اوسطية تعلن في اول موادها على الانتمائية المجتمعية وصياغة هذا الكيان الناظم وفق هذا الانتماء. ولان انتمائية الاغلبية المجتمعية هي انتمائية ذات بنية دينية, فتكوّن بذاتها اسلمة دستورية او تدين دستوري, وهذا ما نراه في عديد من الدساتير العربية وحتى الدستور الايراني:
المادة 13 من القانون الاساسي العراقي 1925:
“الاسلام دين الدولة الرسمي, وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمه لا تمس, وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة, وحرية القيام بشعائر العبادة, وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالأمن والنظام, وما لم تناف الآداب العامة.“
المادة 2 من دستور جمهورية مصر العربية 2014:
“الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.“
المادة 3 من دستور سوريا 2012:
“دين رئيس الجمهورية الاسلام. الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع. تحترم الدولة جميع الاديان, وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ان لا يخل ذلك بالنظام العام. الاحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.“
المادة 1 من دستور ايران 1979 والمعدل سنة 1989:
“نظام الحكم في ايران جمهوري اسلامي, صادق عليه الشعب الايراني باكثرية 98.2% ممكن كان لهم الحق في التصويت, في استفتاء عام اجري في 11 و12 من شهر فروردين سنة 1358 م.ش, الموافق 1 و2 جمادى الأولى سنة 1399 هجرية قمرية }29 و30 اذار/مارس 1979{. وقد تشارك الشعب في هذا الاستفتاء انطلاقاً من ايمانه الراسخ بحكم القران العادل الحق, بعد ثورته الاسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى الامام الخميني.“
المادة 2 من الدستور العراقي 2005:
“الاسلام دين الدولة الرسمي, وهو مصدر اساس للتشريع:
ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.”
تبرز هنا طرافة الارتباط بين عامل التبعية السياسية والانتمائية الوطنية باوضح صورها, فالايمان بحكم الاغلبية هو ما يضفي تبريراً متواصلاَ بالاعتماد على الانتماء الفكري للمجتمع, وهو بنفسه ما يخلق النزاعات والمشاكل المجتمعية التي قد تنذر بحروب اهلية احياناً كما حدث في الحرب الاهلية اللبنانية بسبب الصراع الطائفي. وتبرز الصورة الفردانية ايضاً في مثل هذا التلاحم التفاعلي لتكوين دستور احادي الاطر حين نرى الدستور السوري والايراني يضيق الدائرة اكثر فاكثر, فنجد عبارة “دين رئيس الجمهورية الاسلام” في الدستور السوري وعبارة “بقيادة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى الامام الخميني” توضح مدى امتزاج التبعية السياسية وفرضها على الانتمائية المجتمعية لتكون مبرراً وفاعله حاسمه لها في الجدليات التي ستنتج في لحظات الغضب الشعبي. فبالتأكيد لا تنحسر هذه التركيبة الاستبدادية في المجتمع العربي او الاسلامي فقط, بدليل ان الدستور الصيني ايضاً يحمل تبعية سياسية معترفة بالنص في دستورها وهي خضوع الدولة للمبادئ الاشتراكية الشيوعية, الا اننا لم نرى احتكارية انتمائية لفرد او مجموعة معينة منصوص عليها دستورياً ولا باي شكل كان! هذا ما يجعل حقيقة الاستفتاءات موضوعاً هزلياً في دستور ايران بنسبة 98% ودستور سوريا 99% كأن المجتمع اتفق على حقيقة منطقية لا دستور مركب وهدفه يمثل الجميع, فتتحقق بذلك ما اصطلحنا عليه التدين الدستوري بشكل عام, شاملاً كل انواع الدساتير الخاضعة لانتمائية مجتمعية سواء كانت دينية او فكرية, والتأسلم الدستوري بشكل خاص, بمختلف طوائفه ومذاهبه.
ولان مثل هذه الدساتير وليدة لحظة تاريخية ممزوجة بأيديولوجيات تطمح ان تكون هيمنتها على كل فرد داخل معمورتها, لن يحقق العاملان السابقان سلطانهما على دستور معين بدون ضمان صلاحية تاريخية لا محدودة لهذه الايديولوجية. وقد تنبني هذه الضمانة غالباً على مفارقات ومتناقضات جوهرية, هي بعيده كل البعد عن الاساس المسؤول عن كيان الدستور. فحقيقة الديمومة الدستورية ولامحدودية تاريخ انتهاء صلاحيتها هي واقع محض, لكن ان كانت الصياغة الوضعية مبنية على اساس ايديولوجي, لن تكون هذه اللامحدودية التاريخية الا اداة توظفّت لأجل الديمومة الايديولوجية لا الدستورية. وبالتالي تكون المبررات لخرق الدستور سابقة للخرق بذاته دام ان هذه الحزمة من القوانين قد وضعت لآجل الحفاظ على الجسد الايديولوجي بعينه. ويكاد ان يكون مقصدنا خالياً من حاجة الامثلة ايضاً, كون ما طرحناه من المواد السابقة, وخصوصاً مواد التأسلم الدستوري, قد كشف بشكل واضح مدى الضرورة الملحة لترسيخ الضرورة التاريخية لديمومة لانهائية لهذه الدساتير, الا ان جوهر المواد السابقة يهدف الى العاملين اللذين طرحناهما وناقشناهما لأجل هذه المواد, لذا ففكرة الصلاحية التاريخية تمتلك ايضاً مجموعة من القوانين التي تهدف جوهرياَ لتحقيقها:
المادة 43 من الدستور العراقي 2005:
“أولاً: أتباع كل دين أو مذهب احرار في:
ممارسة الشعائر الدينية, بما فيها الشعائر الحسينية.
ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية, وينظم ذلك بقانون.
ثانياَ: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.“
المادة 140 من دستور مصر المعدل سنة 2019:
“يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهوري أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.“
المادة 5 من الدستور الايراني سنة 1979 المعدل سنة 1989:
“السيادة المطلقة على العالم وعلى الانسان لله, وهو الذي منح الانسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي. ولا يحق لاحد سلب الانسان هذا الحق الالهي او تسخيره في خدمة فرد او فئة ما. والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة.“
تكمل لنا هذه المواد الصورة الحقيقية للدساتير العربية والشرق اوسطية بشكل واضح وصريح, انها دساتير مبنية على فكر ايديولوجي احادي استبدادي ووظيفته استمرار الايديولوجية الحاضنة له وليس تحقيق الاهداف الاساسية لهذه الدساتير. وقد تنظرون الى مسألة الاشارة الى الشعائر الحسينية في المثال الاول, وتمديد فترة الرئاسة في المثال الثاني, وفكرة السيادة الالهية المطلقة في الثالث, على انهم امثلة بسيطة وواردة الحدوث في دستور شعب معين, الا ان المقصد ليس فقط ذكرهم لأجل حدث تاريخي لا يراد تكراره او لضمانة معينه, بل لخلق فرص ايضاً لإدامة فكرة جديدة بواسطة التبعية السياسية والانتمائية المجتمعية من خلالها.
من المؤكد ان كل هذه الامثلة قد اعطتنا الرؤية الواضحة والعميقة للدساتير التي وضعت لدول ما بعد الاستقلال, وهو معنى غياب مفهوم الدولة الحديثة عند هذه الدول, فهي ما استطاعت ان تستفيد من غزاتها ذلك الدرس الثقيل الذي دفعها لهم من خلال دساتيرها التي ترتكز على عاملين لا ثالث لهما: الأنسان والعقل, وبقيت هويتها الدستورية مبنية على تلك العوامل التي تم شرحها, وهي ما تشكل المزيج الذي يرتضي به من خلاله الشارع ويعترض عليه حين لا تلبي متطلباته. فصنعت بذلك دساتير ودول تحمل ديناً ليس له معالم واضحة متفق عليها عند الجميع. ويتخذ شكل التعقيد في ما طرحناه صورة مستحيلة الخلاص من هذه التركيبة الموجودة في طول الجغرافية العربية والشرق اوسطية, الا ان التجربة الاوروبية والغربية تجيب عكس ذلك تماماً, فالمنظومة الدستورية الغربية كانت تعاني نفس العوامل التي تم شرحها, ولم تذق طعم الخلاص الى اليوم لولا تجاوزهم هذه العوامل. لذلك كل ما علينا هو اتباع الخطوات نفسها مع الاستفادة من الاخطاء التي حدثت كتجربة حية وتاريخية لنا. ولان الرحلة الاوروبية ما تحققت دون جهود عقول عظيمة مثل مونتسكيو, فعلينا ان نتخذ منه انطلاقه لنا لحل معضلات هذه العوامل, ومسلطين الضوء على يبعض المؤاخذات التي احتاجت مفكرين بعد مونتسكيو لتجاوزها, وبما يتناسب مع وضعنا العربي الراهن المليء بالتعقيدات المتزايدة يوماً بعد يوم, متوجةً بفرصة جديدة لكتابة دستور عربي بعد عقود من التجارب المجاورة التي اثبتت ان التشبع بهذه العوامل هو اساس بطلانها وخرقها:
“ والقانون على العموم هو الموجب البشري ما سيطر على أمم الأرض طرا، ولا ينبغي للقوانين السياسية والمدنية في كل أمة أن تكون غير الأحوال الخاصة التي يطبق عليها هذا الموجب البشري. ويجب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها بالأمة التي وضعت في سبيلها ما يكون من الاتفاق العظيم معه إمكان صلاح قوانين أمة لأمة أخرى. ويجب أن تكون هذه القوانين موافقة للطبيعة ولمبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد إقامتها، وذلك سواء عليها أكانت موجدة لها كما هو أمر القوانين السياسية، أم كان حافظة لها كما هو أمر القوانين المدنية.” (روح الشرائع, ص55)
لن تثمر جهودنا ابداً ان لم نترجم الحتميات السياسية والقانونية التي طرحناها خلال المقال, فنفسها الحتميات قد تمتلك, او تساهم, بجزء من الحلول التي سنرسم جذورها لربع القرن الذي بدأناه الان. فالربع الاول, بالترابط مع كل المجريات العالمية في نهايات الالفية الثانية, قد رسخ تأكيداً جوهرياً عاماً, وان كان يحمل في طياته بعض الامتدادات الرجعية, على ان مفهوم الحكم والقانون والدستور المتوفرين ليسوا بالصورة المنطقية ولا المفروضة ان تكون نتائجها كما الواقع يظهره الان, باتفاق, ولو جزئي, حتى ضمن الرواسب المجتمعية للامتداد الرجعي التاريخي. والامثلة على ذلك كثيرة مثل مطالبات اعادة الاستفتاء الايرانية وتجربة الحكم المدني السودانية والانتخابات التي اجريت بعد الثورة المصرية واخرها الانتفاضة التشرينية العراقية التي أسست بداية النظر والمراجعة لصلاحية نفاذ وتطبيق اللائحة الدستورية المنضوية على الحكومة التي تحكمهم. اذاً فحتمية ملئ فراغ الخضوع البشري بمفهوم الدستور او لائحة من القوانين هي بالتأكيد مفهوم موضوعي مجرد, ايمان الفرد والمجتمع فيها هو ما يضفي شرعيتها, لكن لا يعني ذلك اننا لا نستطيع برمجتها وتوسيع اطرها, بل ايضاً لا يعني عدم مقدرتنا لرسم مسار لهذا الايمان ان وجد كي لا يحيد عن وظيفته الوجودية ويعلو على من اوجده. ما يعني ان الاساس الذي يجب ترسيخه وبناؤه, سواء على المفاهيم الاساسية لكينونة الدستور او العوامل التي يخضع لها, هو رسم خارطة شعورية ذات توجه واعي عند الفرد في مسألة الدستور الذي ينظمه وينظم من يحكمه, واتجاهات هذه الخارطة تضيق وتتوسع حسب كل طارئ وجديد يصيب المجتمع لكي لا يقع في فخ العوامل الثلاثة. من خلال ذلك نستطيع ان نعين طريقة تحطيم التبعية السياسية, من خلال عدوها الاول وهو الوعي الجمعي بأساس الدستور والديمقراطية, فسواء كانت المنظومة الحاكمة قسرية او منتخبة, وليدة توجه او انتماء اغلبية مجتمعية او اقلية, فهي يجب ان تخضع, بمنظور المجتمع, الى اساس الفكر الدستوري, وان الحكم مهما كان شكله فهو يلبي المتطلبات الاساسية للمجتمع. وهذا مطابق تماماً لتعليق المفكر الفلسطيني عزمي بشارة في لقاءه على تلفزيون سوريا حول احتمالية انشاء حكم اسلامي في سوريا بعد سقوط نظام الاسد:
“ان الديمقراطية ليست قضية حكم الاغلبية وانتخابات, الديمقراطية في اساسها تتمحور حول حقوق المواطن وحرياته, ما نسميها الحقوق والحريات المدنية. هذا يحتاج ان يكون عليه توافق اجتماعي وان يرسى في دستور, بمعنى انه مهما تغيرت انظمة الحكم, سواء جاءوا اسلاميين او علمانيين او يساريين او يمينيين, سيتفقون جميعاً على احترام هذه المبادئ وهي حقوق الانسان وحرياته وحقوق المواطن وحرياته.” (عزمي بشارة, تلفزيون سوريا, 40:26)
يتم اختصار ما طرحناه علاجاً للعامل الاول بمصطلح الاستقلالية التنظيمية, وفحوى الاستقلالية لا يرمي الى تناقضات مع التيارات السياسية وايديولوجياتهم بقدر ما يرمي الى جوهر هذه التيارات ويوحدهم. فما نغفل عنه جميعاً, بسبب التمسك بتلاطم الاختلافات واولوية الحكم, هو ان هناك دائماً تقاطعات في كل التيارات والتوجهات السياسية مهما بلغ حجم كوارثها الايديولوجية, وهذه التقاطعات ناتجة من الجوهر الذي يمثل نواة الحراك السياسي بذاته, وهو دائماَ ما تكون اهدافه الفرد والمجتمع لكن بطرق تعبير مختلفة, فيكون تجاوز التبعية السياسية بإرساء الاهتمام بالتقاطعات الجوهرية لكل التبعيات السياسية بدل التركيز في الاختلافات الوظيفية, والتي تساهم بذاتها بخلق نموذج حكم ودستور ايديولوجي استبدادي, لا يهمه حصول الفرد والمجتمع على جوهر الحراك بل تطبيقه لما يطرحه الحراك فقط.
يمثل الحل المطروح للتبعية السياسية نصف الطريق لحل عامل الانتمائية المجتمعية, فالأمواج المجتمعية الهائجة جراء التفاعل الايديولوجي بين ماهية الانتماء الفكري للمجتمع, او فئة من المجتمع, وبين ماهية النص الدستوري الذي يطمح اليه. وذلك جلي كفاية حتى مع توسيع الاطلاع لأبسط الاشياء التي لم نشر لها مثل القسم الدستوري لأي حاكم يحكم البلاد, فهو مرهون بطابع ديني يفرض حصراً ايمان الحاكم به, ما يحتم تضييق الدائرة للطاقات الكفؤة بحسب معتقدهم لا هويتهم الوطنية الاساس. وقد يبدو للقارئ ان الطرح هنا يميل الى العلمانية كحل لفكرة الانتمائية المجتمعية, الا ان الفكرة العلمانية هي بحد ذاتها خاضعة لمبدأ الانتمائية المجتمعية وتحققها بنفس الوقت. ذلك ما يوسع لنا ما نعنيه بفكرة الانتمائية المجتمعية ومدى ضرورة تجاوزها والخلاص منها, ولا يتحقق ذلك الا بتحرر الانتمائية المجتمعية من واقع الحكم الظاهري, فيجب فصل الانتمائية المجتمعية عن هيكلية الحكم اولاً, وفصل الرؤى المحمولة لكل شريحة تحمل انتماءً معيناً عند المجتمع عن اساسيات القانون والدستور الذي يجمع كل هذه الانتماءات.
لم تكن فكرة حل الانتمائية المجتمعية مطروحة بشكل جدي حتى مع قادة التحرر الفكري الاوروبي مثل مونتسكيو, بل انها على العكس قد امتزجت كقاعدة حتمية مخالفة لما نراه اليوم من الالزام الاساسي لفصل الانتمائية العقائدية لدى الشعب وافراد النظام عن المنظومة التي تحكمه وقواعدها, فنراه يؤكد ذلك بالقول:
“ويُعَدُّ الأمير الذي يحب الدين ويخشاه كالأسد الذي يذعن لليد التي تلاطفه أو للصوت الذي يُسَكِّنه، ويُعَد الأمير الذي يخاف الدين ويمقته كالوحوش التي تقرض القيد الرادع لها من الانقضاض على المارين، ويُعد الأمير الذي لا دين له كالحيوان الهائل الذي لا يشعر بحريته إلا إذا مزَّق وافترس. وليس الأمر أن يُعرف هل الأفضل ألا يكون للرجل أو الشعب دين من أن يُساء استعمال الدين الذي له، بل أن يُعرف ما هو أقلضررًا أإساءة استعمال الدين أحيانًا أم عدم وجود دين بين الناس مطلقًا.” (روح الشرائع, ص765)
وما ينتج من بقاء تمسك مؤسسي المفهوم الحديث للدولة والدستور, كما نراهم اليوم كمؤسسيين بالفعل, لامتزاج الانتمائية المجتمعية, كما طرحناها واظهرنا ثغراتها, هو رؤيتهم التقييمية للدين, فيميلون الى النصرانية كديانة اوروبية اساسية, مؤكدين انها الديانة المناسبة لصنع حكم مدني ديمقراطي امبراطوري, وان باقي الديانات, كالدولة الاسلامية التي كانت العدو الاول في فترته, ليس لها من الشأن او المقدرة او المواصفات التي ستسمح لها ان تكون حكماً ودولة حرة بمفاهيم المؤسسيين كأمثال مونتسيكو. ذلك ما يؤكده الفصل الكامل الذي كتبه بعنوان (الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام) ويبرر ذلك بعدة طرق منها:
“وإذ إن هذا الدين يُحَرِّم تعدد الزوجات فإن الأمراء يكونون به أقل احتباسًا، وأقل انفصالًا، عن رعاياهم، ومن ثَم أكثر رجولة، وهم يكونون أكثر استعدادًا لإلزام أنفسهم وأعظم قدرة على الشعوب بأنهم لا يستطيعون كل شيء.” (نفس المصدر, ص767)
يؤكد لنا كل ذلك مدى حساسية فكرة فصل الانتماء المجتمعي عن الفكرة الدستورية, فأي محاولة عكس ذلك ستنذر بأدلجة فكرية تستغل لأغراض استعمارية على النحو الخارجي للدولة والاستبدادي على النحو الداخلي لها. ومن اللطيف ان نرى كل الكلام الذي قاله مونتسكيو قد سبقه رؤيته للفرق بين حرية النظام وحرية المواطن, فمن المؤكد انه كان يمتلك من الشكوك ما يكفي لتحقيق الانتمائية المجتمعية فكرة دولة مدنية او دستور قوي كما نفهمه اليوم:
“لا يكفي أن تعالج الحرية من حيث صلتها بالنظام، بل يجب أن تُرى من حيث صلتها بالمواطن . . . وقد يكون النظام حرٍّا، ولا يكون ابن الوطن كذلك مطلقًا، وقد يكون ابن الوطن حرٍّا، ولا يكون النظام حرٍّا، وفي هذه الحال يكون النظام حرٍّا حقوقًا لا فعلًا، ويكون ابن الوطن حرٍّا فعلًا لا حقوقًا.” (روح الشرائع, ص338)
بحل العاملان السابقان نكون قد مهدنا الطريق لحل العامل الاخير لمعضلة كتابة الدستور. وبالتأكيد ان اغلب الدساتير التي تم تسليط الضوء عليها هي دساتير موضوعه ايديولوجياً واستبدادياً, ما يعني ان صلاحيتها التاريخية هي شبه مفروضة على المجتمع, الا اننا لا نسعى لحل هذه الجزئية بطريقة ما, لان لا طريقة سلمية لها, بل الانتفاضات والثورات الشعبية هي ما تسقطها. لكن هدفنا الاساسي هو كيفية ضمان عدم تسلسل هذا العامل بعد سقوط منظومة دستورية معينة واختراقه لها بصورة جديدة. ومفتاح هذه الضمانة هو عدم تضييق الرؤية الدستورية لتشمل الاحداث والظروف الزمنية التي يعيشها الفرد, فمما لا شك فيه ان فرصة كل منظومة حاكمة تحصل على فرصة كتابة عهد جديد لامة ما هو صياغة هذا الدستور بصلاحية تاريخية, اي تاريخ بدايته هو الاحداث التي دفعت لكتابته وتاريخ انتهاءه هو حين لا يعود المجتمع متقبلاً بقاء هيمنته عليه. ولن يحدث ذلك الشيء الا بقناعة شعبية ان الحقوق والواجبات الانسانية العامة ان توفرت في النص الدستوري فان الاضافات الثانوية التي تضاف, سواء للتاكيد عليها او لفرض وجودها, هي ذاتية التحقق ان ضمن الجميع حقه وتم تطبيق الدستور في حذافيره. فان حدث ذلك, مع تجريد المجتمع وكيانه الحاكم من التبعية السياسية والانتمائية المجتمعية, فسنضمن لهذا المجتمع دستوراً موضوعياً منطقياً جديداً يستطيع ان يتبعه ويضمن ان الاخير سينقذه مهما عصفت الاحداث الداخلية والاقليمية والعالمية به. وهذا ما ننتظر ان نراه حقيقهً بفارغ الصبر لدستور سوريا التي حصلت على ملكة الحرية من ابشع الديكتاتوريات التي مرت على الدول في القرنين الاخيرين.
يتلخص مقالنا بفكرة بسيطة, وهي ان اعظم المفارقات الموجودة في الدساتير العربية هي تشابهها الدائم في تناولها حقوق وحريات الافراد المحكومين في هذه الدساتير, الا ان التفاصيل البسيطة التي تتمثل في هذه العوامل الثلاث هي ما تحكم بعدم تطبيقها الا ضمن المفاهيم التي تحملها. ومن بدائع البشر انهم فكروا بقضية تجاوز فكرة الحكم والدستور اصلاً وجعل الانسان يحكم نفسه بنفسه, وهي الفكرة الاناركية, وبالحقيقة هي اقدس فكرة سياسية رايتها قد تبلورت في القرن العشرين, على يد الاوكرانيين, رغم استحالة تطبيقها بشكل كامل, فهي ترسم شكلاً ملكوتياً للإنسان يستطيع من خلالها ان يخلق جنة في ارضه, من خلال ان يحيي القوانين بقلبه وعمله وينتزع الخضوع لها لأنها ستكون ممزوجة بإرادته. لكن حتى عدم وصولنا لهذه المثالية هو ليس سيئاً كما يبدو, فنحن بإمكاننا ان نخلق قوة, نؤمن بها ونخضع لها, مبنية على اسس انسانية واجتماعية بحته, بعيدة كل البعد عن التفرعات البشرية التي قد تدفع لإشعال الخصومات والتنافرات والمعارك الداخلية, فكما بدأنا في بداية ربع هذا القرن بفهم معنى الحكم المستقل وضبط التوجهات المجتمعية المختلفة, مجبرين الكثير من القوى السياسية في المنطقة العربية والفارسية على لبس لباس الاستقلالية والمناداة بالحقوق الاساسية, بعد ان كان الخطاب عن التوجهات فخراً لهم, ستكون خطوة ربع القرن الحالي هو اسقاط الدساتير العربية وبلاد فارس وحل محلها دساتير لا تقع اسيرة التبعية السياسية المؤدلجة, والانتمائية المجتمعية المحرضة ولا حتى ذات صلاحية تاريخية محددة, لنضمن عيش الجميع تحت مسمى المواطن لا ما يحمله من انتماءات وتوجهات وممارسات.
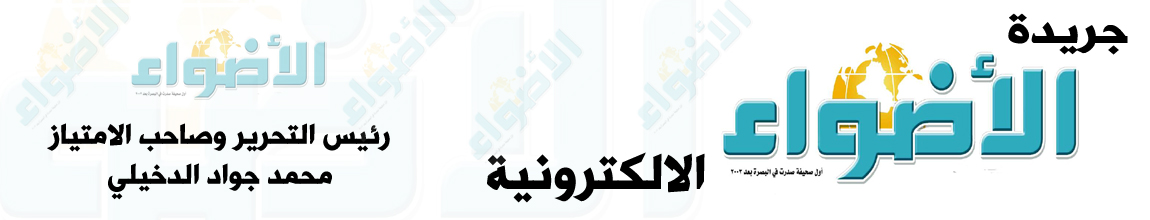 جريدة الاضواء الالكترونية
جريدة الاضواء الالكترونية